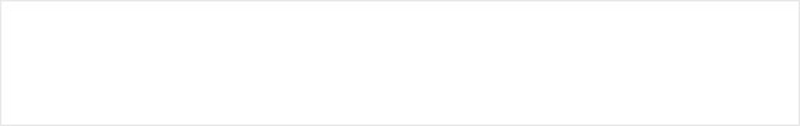تسجيل وإعداد:د. خالد محمد باطرفي
أزمة الحرب العالمية الثانية
غير أن تفكيري هذا والذي كان منصباً وقتها على الإستيراد اصطدم باشتعال الحرب العالمية الثانية والتي ظهرت نذرها عام 1937 م ( 1356هجرية ) وأشتعلت عام 1939 واستمرت حتى 1945م، أي قرابة ثمان سنوات .
وخلال هذه الفترة السوداء في تاريخ الإنسانية، توقف الإنتاج المدني واتجهت المصانع العالمية إلى الإنتاج الحربي وأصبح الاستيراد متوقف تقريباً، ماعدا بعض البضائع عن طريق (الكويت)،
وتضاعفت أسعار البضائع عشرات الأضعاف .. ماعدا المواد الغذائية، حيث يعود الفضل في ذلك، بعد الله، إلى سياسة الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله، بأخذ موقف حيادي من الحرب، وإن كان يميل إلى الغرب، فجنب بذلك بلاده ويلات الحرب التي نالت جل بلاد العالم. وأستفاد من هذا التوازن السياسي والسلام الذي عم البلاد في وضع خطة أمن غذائي لمواجهة آثار الحرب.، حيث ركز رحمه الله على توفير المواد الضرورية مثل (الخبز و الأرز و السكر و الشاي والقهوة) بأسعار لم تزد عن المتعارف عليه، وفي بعض الحالات مجانا، مثل الخبز.. حتى أنه أوجد مطاعم تقدم الوجبات مجانا .. وأذكر منها مطعم (خريمس) في الرياض ومطعم ( القنيعير ) في مكة المكرمة … وكان نوع الوجبة هو (الكبسة ) المكونة من اللحم والرز، وكان يعد بشكل جيد ومتاح للفقراء بكل يسر .. إضافة إلى عيش الصدقة الذي كان يوزع بالمجان على الأسر المحتاجة .
السفن الغربية تحرس بواخر الغذاء للمملكة
لقد كانت قيادة الملك عبدالعزيز رحمه الله حكيمة جداً حيث كان ينتزع قوت شعبه من براثن الأسود المتصارعة في تلك الظروف العصيبة، وفرض أحترامه وهيبته لدرجة حراسة سفن الحرب الغربية للبواخر التي تحمل المواد الغذائية إلى المملكة عبر البحار الملغومة والمهددة بكل أسلحة الدمار .
يحدث هذا في الوقت الذي كان فيه الأوروبيون أنفسهم يجدون صعوبة في الحصول على لقمة العيش أثناء تلك الحرب المدمر، حتى أن الدول الأوروبية كانت توزع الطعام بالكوبونات، فلا يصل السكر، حتى إلى المطاعم والفنادق والقصر الملكي إلا بمقادير محددة وبكميات متقشفة.
ولكن، مع توفر المواد الغذائية الأساسية في بلادنا، تضاعفت في المقابل أسعار الكماليات وبدأت تشح من الأسواق مما انعكس سلبياً على حياة الناس.
ولعي بالعلوم التطبيقية والطبيعية
كنت في السابعة عشر من عمري عندما تمكنت من تغيير نهج تجارة الصباغ من التوزيع إلى الإستيراد .
وبعد نشوب الحرب لاحظت حاجة السوق الماسة إلى بعض المواد المصنعة غير الغذائية.
وقد التقت تلك الحاجة مع ميولي الشخصية الدراسية نحو العلوم الطبيعية والتطبيقية كالكيمياء.
ولأن الوالد، يرحمه الله، قد أقفل عليً باب مواصلة تعليمي، فقد أخذت في البحث عن طريقة تجعلني متصلا بتلك العلوم بشكل يتقبله، فاستأذنته في السماح لي بالاستفادة من الأساتذة (المصريين) الذين كانوا يقومون بتدريس الطلاب في مدرسة تحضير البعثات، وخاصة المعلمين المتخصصين في مادة (الكيمياء)، بعد انتهاء عملي في الدكان، لأخذ دروس خصوصية لديهم، فأذن لي.
الدروس الخصوصية بديلا للـ”الصياعة”!
كان ذلك بمثابة دخول مغامرة جديدة لاحظ الوالد تعلقي بها ولم يعلق عليها، لأنه كان يعتبرها نوعا من استغلال وقت الفراغ، بدلاً من “الصياعة”، التي كان يصف بها الشباب الذين لايشغلون اوقات فراغهم بما يفيدهم .ففي الوقت الذي كان الشباب ينتشر في “القهاوي” الشعبية، خاصة في أطراف مكة، ويقضون أوقاتهم في اللهو والطرب واللعب، حسب ظروفهم المادية ومساحة أوقات الفراغ المتاحة لهم، كنت وأخوتي لا نخرج من المدرسة أو الدكان إلا للمسجد الحرام أو المنزل، بما في ذلك إجازات نهاية الأسبوع والإجازات المدرسية.
وفي أحسن الظروف كنا نحضر المناسبات الإجتماعية لأداء الواجب أو نستضيف الأهل والمعارف. وكان ذلك قمة التسلية وأقصى ما نحلم به. وفي الصيف قد نقضي بضعة أيام أو أسابيع في الطائف، عندما تصل درجة الحرارة في مكة المكرمة إلى معدلات يصعب إحتمالها في غياب المكيفات وحتى المراوح، حتى كنا نضع الأقمشة المبلولة على الشبابيك لتخفف من حرارة الرياح الساخنة قبل دخولها البيت، فتنشف بعد وقت قصير، لنعيد بلها من جديد.
تصنيع فناجين الشاي
تمثلت مغامرتي (العلمية-التجارية) في أن أقوم بتصنيع بعض المواد الكمالية الإستهلاكية التي شحت في السوق وأدى إرتفاع الطلب عليها إلى تزايد أسعارها عشرات الأضعاف.
فكرت أولا في تصنيع الزجاج بعد أن لاحظت بأن سعر فنجان الشاي وصل إلى خمسة ريالات وهو مبلغ باهظ في ذلك الوقت، ويعادل اليوم خمسين ريالا تقريبا أو أكثر .. فتصورت أن صناعة فناجين الشاهي يمكن أن تدر أرباحاً خيالية لتجارة الوالد.
لم تكن حاجيات الناس في ذلك الوقت كثيرة أو معقدة كما هو حالنا اليوم .. فلم نكن نعرف الإلكترونيات ولا الكهرباء ولا الراديو ولا التـــلفزيون. وأغلب المتطلبات لا تزيد عن الغذاء والكساء والدواء والقهوة والشاي، إضافة إلى الصابون والنشأ ومستلزمات غسيل الملابس.
أما الغذاء، فكما ذكرت، كفانا الله همه بدعم من ولي الأمر جزاه الله خيرا، بعد توفيق الله عز وجل، وأما الدواء فقد تكفلت دكاكين العطارة بالوصفات الشعبية التي كانت الطبابة الرئيسية في ذلك الوقت وقاعة الشفاء في مكة المكرمة.
تجربة تصنيع الزجاج
بدأت تجاربي البدائية في تصنيع فنجان الشاي، وهي أيضاً صناعة غير معروفة في بلادنا وقتها، ولم أجد أي مرجع علمي يفيدني في هذا المجال .
ولهذا بدأت من الصفر فاتجهت إلى مجامع النفايات للبحث عن مخلفات الزجاج المكسور وغير الصالح للاستخدام، وعملت على صهرها في بوتقة مصنوعة من الرمل وبرادة الحديد حتى تتحمل درجات الحرارة العالية .
وقد استفدت في الحصول على البوتقة مما يستخدمه (الصاغة) في ذلك الوقت لصهر مختلف المعادن كالذهب والفضة .. حيث قمت بتسليط اللهب، ووقودها الكيروسين، على تلك البوتقة وبداخلها الزجاج .. إلا أن تلك الحرارة العالية لم تفلح في صهر الزجاج بالرغم من أنها كانت أقوى وسيلة معروفة لدينا آنذاك .
واتضح لي بعد ذلك أن الزجاج يحتاج لإذابته إلى درجة حرارة أعلى من تلك الحرارة بكثير، لم تكن هناك وسيلة تحققها.
استخدمت المرايا المقعرة لصهر الزجاج
اتجهت إلى فكرة جديدة وهي أن أقوم بوضع الزجاج في البوتقة محاطة بحوالي خمسين مرآة مقعرة تحت أشعة الشمس، بحيث تتركز الأشعة الناتجة من كل مرآة في نقطة واحدة، وتتجمع مع باقي النقاط من المرايا الأخرى، وتركز على البوتقة. ولبست نظارة شمسية ثقيلة لحماية عيني من ضوء الشمس، وهكذا نجحت بفضل الله عز وجل في إذابة الزجاج، وأمسكت البوتقة بملقاط من الحديد لأصب الزجاج المنصهر في قالب. ولكن الزجاج لم يكن على درجة كافية من السيولة بحيث يملأ القالب .
وللأسف لم تكن لدي المعلومات الكافية لصناعة الزجاج وكيفية التعامل مع المادة اللزجة النصف سائلة في داخل البوتقة. وقد عرفت فيما بعد أنه يتم التعامل مع هذه المادة في مصانع الزجاج عن طريق النفخ، وليس بصب السائل.
وهكذا توقفت محاولاتي لصناعة الزجاج في منتصف الطريق، ولم أكمل تجاربي.
عملت في مجتمع إستهلاكي مغلق
لقد كنت أعمل في مجتمع إستهلاكي مغلق، غير صناعي، اللهم إلا إذا حسبنا الصناعات التقليدية اليدوية، كصناعة السيوف والجلود والمباخر. كم كنا نفقتد إلى المعلومات ووسائل الوصول اليها، والى سرعة التواصل مع المجتمعات الصناعية المتقدمة، في زمن كان الجمل فيه الوسيلة الرئيسية للنقل والمواصلات.
فلم تكن عندنا مايتوفر اليوم من خدمات إتصال سريعة ورخيصة وسهلة الإستخدام، عن طريق النت والأقمار الصناعية، وعبر الهاتف والفاكس وغيرها من وسائل الإتصال. ولم تتوافر لنا المكتبات الحديثة، والصحافة المتخصصة، والإعلام الحديث. وكانت الصحف الأسبوعية القليلة المتوفرة في ذلك الوقت كجريدة أم القرى الرسمية وجريدة صوت البلاد، تعتمد هي نفسها على الراديو لنقل الأخبار الدولية، خاصة أخبار الحرب العالمية، ويندر اهتمامها بالعلوم والتقنية الحديثة.
كل هذه العقبات، وغيرها مما لا يتسع له المقام، حالت بيني وبين النجاح في صناعة الزجاج أو غيره مما تحتاجه البلاد .
.. واستمرت التجارب!
لم يقعدني فشلي في تصنيع الزجاج وبالتالي صناعة فناجين الشاي التي كانت ستدر علينا أرباحا طائلة عن التفكير في صناعات أخرى .. ذلك لأنني أيقنت بأن فشلي لم يكن بسبب تقاعسي أو عدم إمكانية وصولي إلى أسرار صناعة الفناجين، وإنما بسبب عدم توفر المعلومات، والآليات التي يمكن أن تخدم عملية التصنيع تلك.
وهكذا اتجهت الى طرق باب تصنيع آخر لا يكون بحاجة إلى تجهيزات غير متوفرة، فبحثت عن احتياجات شح وجودها وارتفعت أسعارها، تكون في حدود إمكانياتي المادية والعلمية والخامات المتاحة، وتوصلت إلى الصابون.
البحث في مكونات الصابون!
لم تكن لدي خلفية علمية في تصنيع الصابون غير ما تلقيته من الكتب التي درستها في الإبتدائية، وتلك التي تُدرس في مدرسة تحضير البعثات. ولكن للأسف كانت كلها توضح بشكل عام، وليس على وجه الدقة، كيفية صنع الصابون.
والطريقة هي أن يمزج خليط من (الصودا الكاوية) مع مقدار معلوم من الزيت ويغلى المزيج فينتج عن ذلك الصابون .. ولكن أين هي الصودا الكاوية؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟
وبالبحث والتقصي في الكتب المتوفرة لدى بعض أساتذة مدرسة تحضير البعثات وما لدي من الكتب، وأهمها كتاب (الدر المكنون في الصناعة والفنون)، وجدت أن الصودا الكاوية تصنع بإضافة محلول (بيكربونات الصوديوم) إلى محلول (بيكربونات الكالسيوم).
إعادة اكتشاف (الكربونه) و(الرخام) و(النوره)!
ولكن هذه المسميات ظلت بالنسبة لي ألغازا طالما لم أجدها على أرض الواقع، حتى أكتشفت فجأة أنها متوفرة في محلات العطارة باسم (كربونة)، ولو سألت العطار عنها بالإسم العلمي لها (بيكربونات الصوديوم) لما عرفه.
وتستخدم الكربونة لسرعة استواء الطعام في بعض الأغذية مثل “الفاصوليا الناشفة” و”الحمص” و “البليله” .. كما تستخدم في بعض المعجنات ويطلق عليها ” صودا الخبز “، ولها استخدامات أخرى كثيرة عرفتها من العطار وتغيب عني الآن.
بعد أن اشتريت الكربونه بحثت عن الاسم البلدي لـ(بيكربونات الكالسيوم)، وعرفت انه (الرخام)، ويستخدم في طلاء المنازل باللون الأبيض (النوره) .. إذ لم نكن نعرف انواع الدهانات والطلاء وورق الجدران من الداخل، ومن الخارج حجر القدس وانواع الرخام والمواد التي تزين بها المنازل حاليا. ففي أحسن الظروف كان البعض يمزج “الأصباغ” الملونة مع النورة البيضاء ليغير من لون الطلاء داخل أو خارج منزله .
صنعت (الصابون) وافتقدت (الماركة)!
اشتريت (الكربونه) من العطار و(الرخام) من محلات بيع مواد البناء، وغليتهما معا ثم مزجتهما مع الزيت حتى توصلت بفضل الله عز وجل إلى تصنيع الصابون .
وبنشوة النجاح بشرت الوالد رحمه الله بهذا الإنجاز الذي توصلت اليه، وشجعني الوالد لكنه نبهني قائلا (المهم يا إبني كيف تبيعه في السوق؟!). و كان سؤالا في محله، إذ أن في السوق ماركات شهيرة من أنواع الصابون المستورد مثل ماركة (أبو عنز) و(أبو عجلة) وهي علامات كانت تطبع على قوالب الصابون .
فكرت أن أستفيد من شهرة هذه الماركات (التي انقطعت بسبب توقف الاستيراد لظروف الحرب العالمية الثانية) بوضع علاماتها على الصابون الذي صنعته، وكان علي إيجاد أختام تحمل تلك الماركات .
ذهبت إلى صنايعي تركي يصنع أختاماً عند “باب الزيادة “، وطلبت منه أن يصنع لي ختماً، وكانت المفاجأة ان رفض طلبي، وقال: يا بني إن هذا ليس من حقك إنه من حقوق أصحاب الماركة. فجادلته : ولكن البضاعة غير موجودة في الأسواق! فرد بالقطع: إن هذا لا يبرر لك استعمالها حتى تستأذن من أصحاب تلك الماركات!
كانت تلك لمحة أخلاقية إمتاز بها ذلك الجيل .. فقد نبهني، رحمه الله، إلى مسألة خطيرة لم تخطر على بالي في ذلك الوقت .ولنعد إلى الصورة اليوم، لندرك حجم المواد “المغشوشة” التي تمتلئ بها الأسواق حاليا، وتعداد المصانع الآسيوية التي تضخ ملايين المنتجات المقلدة، والتأثير السلبي والخطير لتلك المواد المقلدة على الحقوق الفكرية والتجارية لأصحاب العلامات .. وعلى صحة الناس وسلامتهم.
فشل تجربة تصنيع الصابون!
ولعل الله أراد بي خيرا، فإضافة إلى الدرس التجاري والأخلاقي الذي تعلمته من صانع الأختام التركي فإن المشروع لم يكن لينجح على أي حال. فمراحل إنتاج الصابون تحتاج إلى جهد جماعي وإمكانات مادية أوفر ووقت أكثر، ولم يكن هذا كله متاح لصبي لم يتجاوز السابعة عشر عاماً عمله الأساسي إدارة دكان (الصباغة). كما أن عملية التسويق لم تكن بالسهولة التي كنت أتصورها، بحماس وطموح الشباب، مع محدودية الخبرة في السوق. ولم يكن هناك من التجار من ألجأ اليه أو من الخبراء والمتخصصين من أستعين به، فلم يكن لي معينا أو مشجعا غير المولى عز وجل، ولا دافعا غير أحلامي وإصراري على عدم القبول بالواقع، والعمل على تحسينه وتطويره.
أخلاقيات جيل نبيل
أعود إلى الموقف النبيل لصانع الأختام التركي، فأذكر أن الجيل الذي عاصرته كان يتمتع بأخلاقيات نادرة في عالمنا اليوم .. فالأمانة، وحفظ حقوق الغير، والصدق، وغيرها من السمات الجميلة كانت علامات بارزة في تعاملات الناس .. ليس في التجارة فحسب وإنما في صلات الناس ببعضهم البعض .
ويخطر ببالي الآن وأنا أسجل هذه اللمحات من حياتي قصة تذكرتها الآن عن تلك الأخلاقيات الراقية عن أحد أصدقاء الوالد، العم حسن رواس، الذي كان يزورنا بين الحين والآخر في دكان (الصباغة) بثيابه الناصعة البياض والشديدة النقاء، ليقضي بعض الوقت مع الوالد قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة .فقد كانت الزيارات بين أصحاب المحلات كانت أمرا تقليديا ومتعارفا عليه.
حكاية العم حسن رواس!
كان لدى العم حسن دكان في (الحلقة) وذات يوم تشاجر أخوه مع أحد أصحاب الدكاكين المجاورة، فقام الأخ بضرب جاره وشج رأسه .
شكى المعتدى عليه إلى الشرطة فطلبت منه شاهدا فقال لا أعرف أحداً شهد الحادثة سوى أخو المعتدي. أحضر الشيخ حسن رواس إلى مقر الشرطة فأدلى بشهادته ضد أخيه.
وفي اليوم التالي ذهب لزيارة أخيه في السجن فصدّ عنه احتجاجاً على موقفه الذي لم يكن يتوقعه، فرد عليه: أتريد مني أن أكتم نور الله؟!
وقام العم حسن برعاية أسرة أخيه إلى جانب رعايته لأخيه حيث كان يبعث له بالطعام في سجنه.
في ظل ذلك الجو الأخلاقي النبيل كانت تعيش مكة المكرمة ويتلقى الجيل الأصغر من الجيل الأكبر دروساً عملية في المثل والخلق .
ضربتين في الرأس توجع!
لم يفت في عضدي عدم نجاح أول تجربتين صناعيتين لفناجين الشاي ثم الصابون، ففي الحالتين توصلت إلى الحل العلمي وعجزت أمام عدم توفر الإمكانات .. ذلك أن طبيعتي ولله الحمد لا تعرف اليأس، وعندما تصادمني مشكلة أو معضلة في أي مجال فإن ذلك لا يضعف عزيمتي ولا يفت في عضدي .
ولذا توجهت إلى مجال آخر في نفس الإطار الصناعي الذي أعشقه، ليلبي أحتياج المجتمع، والحاجة أم الأختراع. وكانت الحاجة ملحة إلى إيجاد مادة تساعدنا في إزالة الأصبغة التي تعلق بملابسنا وتشوه المنظر العام ولاسيما الثياب البيضاء .
معضلة البحث عن (الكلور)!
سألت أستاذي إذا كانت لديه فكرة في إستعمال مادة تساعد في إزالة هذه الأصبغة، فأشار إلى مادة (الكلور)، وهو المستخرج من مادة (كلوريد الصوديوم) .
وسألته عن ماهية (كلوريد الصوديوم)، فوجدت أن معرفته بذلك لا تزيد عن معرفتي، وبذلك بدأت مرحلة شاقة في التحري والبحث في الكتب الكيميائية والصناعية عن هذه المادة حتى عرفت أن (كلوريد الصوديوم) هو ملح الطعام الذي نستعمله في أكلنا صباحاً ومساءً، وهو الذي يدخل في ملوحة مياه البحر بدرجات متفاوتة، كما توجد تلال وجبال من الملح في مناطق كثيرة من العالم. ففي بلادنا تتوفر هذه الأملاح الطبيعية بكميات تجارية في مناطق، كمنطقة جازان، وأتمنى أن ننشأ مصانع للملح لاستغلال هذه الثروة الطبيعية، يغنينا عن استيرادها.
التكوين الكيميائي لـ(كلوريد الصوديوم)
هذه المادة العجيبة كيف تكونت؟ وكيف اتحد عنصر الكلور الغازي مع عنصر الصوديوم ليكون هذه المادة التي تلبي حاجة الإنسان؟ أما إذا فصل عنصر عن الآخر فيشكل بمفرده عنصراً ساماً خطراً على الحياة! فالكلور غاز سام إذا إستنشقناه، والصوديوم مادة كاوية إذا لامست الجسم، ولكن الكلور كمنتج صناعي يستخدم لإزالة الألوان إذا أذيب في الماء .سبحان الخالق العظيم!
أخبرني أستاذي بأنه يمكن الحصول على الكلور بتمرير تيار كهربائي في محلول مركز من كلوريد الصوديوم، فينفصل العنصران ويصعد الكلور على شكل غاز أصفر يمكن أن يذاب في الماء بأنبوب آخر .
كان عند الأستاذ علم بهذه العملية الكيميائية المبسطة، ولكنه لم يكن يعرف كيف نحصل على كلوريد الصوديوم .. في هذا الجو الغامض من الألغاز العلمية والمعرفية، كنت ألتقط المعلومة من هنا ومن هناك لأصل إلى الهدف .
نجاح التجربة الصناعية الثالثة!
نجحت بفضل الله في إنتاج الكلور على شكل غاز مذاب في الماء وأستعملته في تنظيف ثيابي وثياب العاملين معي في دكان الصباغ. ثم إستخدمته في تبييض بعض الخيوط الرمادية اللون لتظهر ببياض ناصع وتباع بضعف ثمنها بعد أن يبيض لونها، وعهدت بها إلى دكان خالي ليبيع بعضها، لأن دكاننا لا يتسع لذلك .
كما قمت بتعبئة الكلور في قوارير معقمة ولف هذه القوارير بورق أسود يتمشى مع التعليمات الصناعية حيث أن الكلور يفسده الضوء .
إستخدمت الكلور في تغيير كثير من الخيوط القطنية والخيوط الحريرية، ذلك أن ألوان بعض الخيوط القطنية والحريرية غير مرغوب فيها، فعندما تبيض بمادة الكلور يمكن صبغها بألوان أخرى غير موجودة في السوق .
تحدي الإمكانيات .. مرة أخرى!
وبالرغم من عدم قناعة الوالد بما أمارسه من تجارب لصناعة الصابون والكلور لاعتقاده بعدم جدواها الاقتصادية، إلا أنه لم يمانع من استمراري في تلك التجارب رغبة منه في أن أشغل وقتي في هواياتي التي لا يرى ضرراً منها.
لم يكن استخراج الكلور بطريقتي التي يمكن أن اسميها (علمبدائية)، أي العلمية البدائية!، نهاية المطاف بالنسبة لي .. فقد كان هاجسي من كل تجاربي في الزجاج والصابون والكلور أن تكسب تجارة والدي، وأن نصنع ونسوق مايحتاجه السوق عن طريق ابتكار مواد مطلوبة وغير متوفرة، وبذلك نوفر احتياجات المستهلكين ونتميز بتجارتها. لكن الإمكانات التصنيعية لم تكن متوفرة، فالزجاج وما ينتج عنه من صناعات استهلاكية، كالفناجين والكاسات، والصابون والكلور، كلها تنتج اليوم في مدننا الصناعية في مصانع كبيرة وبرؤوس أموال ضخمة وخبرات وشراكات صناعية دولية، وليس عن طريق شاب لم يتجاوز سن المراهقة وأدواته لاتتعدى أوعية منزلية بسيطة، وكميات متواضعة من المواد الخام .
جاء دور (النشا)!
ومع ذلك لم تتوقف طموحاتي عند ماقمت به، بل أخذت أفكر في تصنيع مادة ربما تكون أكثر توفرا، وأسهل تجربة، ويمكن إنتاجها بكميات تجارية .. فرغم توقف تجاربي في الصابون،
وانحسار جدوى تجربة الكلور في الحصول على كمية بالكاد تفي بأغراض تبييض الملابس، إلا أن حماس الشباب يتفاعل في داخلي ويشجعني نحو الاستمرار ويصور لي إمكانية تصنيع مادة أخرى .. فقد كانت تجاربي العلمية (لا التصنيعية والتسويقية لها) ناجحة والحمد لله.
لكن السؤال هو: ماهي هذه السلعة التي أريد تصنيعها ويحتاجها الناس وغير متوفرة في السوق؟ وهو سؤال لم تستغرق الإجابة عليه أكثر من مصادفة غريبة تمثلت في مشاهدتي للعم حسن رواس في ثيابه البيضاء الناصعة النقية، مرتديا الكوفية (المنشاة) التي تتوسط عمة الرأس المكاوية.
فقد أوحى لي مظهره الراقي الجميل بفكرة تصنيع مادة (النشا) حيث كانت سلعة رائجة يحتاجها الناس لإعطاء قوام للثياب البيضاء والكوافي . وهي أيضا سلعة شح وجودها في الأسواق، وليست على درجة كبيرة من الأهمية كالأغذية التي سعت الدولة كما سبق وذكرت الى توفيرها للناس في زمن الحرب العالمية .
“النشا” آخر تجاربي العلمية!
عرفت بأن (النشا) مادة طبيعية تستخرج من الذرة، فأحضرت كميات من الذرة البيضاء كما نسميها في مكة.
وبعد محاولات عديدة ومضنية استطعت بعون الله تعالى استخراج النشا من الذرة البيضاء، ولكن بطريقة بدائية حيث وضعتها بعد تنظيفها من غلافها الخارجي في إناء مملوء بالماء لعدة أيام حتى تلين ثم أخرجتها، وهرستها بعجلة غليظة استخدمتها كـ(مهرسة) حتى استخرج المادة النشوية الموجودة في قلب كل حبة من الذرة.
وكانت عملية الهرس تلك عملية شاقه حيث كان علي أن أضمن عدم اختلاط المادة النشوية المستخرجة بمكونات الغلاف المحيط بهذه المادة .
وبعد تصفيتها حصلت على النشا بطريقتي الخاصة، إذ لم أكن أعرف الأسلوب الصناعي لاستخراج النشا، لكنها كانت اجتهادات شخصية تكللت بعد توفيق الله عز وجل بالنجاح .
وهكذا أصبح لدينا نشا ولكن أيضا بكميات قليلة لبدائية الوسيلة وضعف الإمكانات، فلم تفي بحجم الطلب.
كان النشا آخر تجاربي نظرا لحدوث تطورات ومستجدات غيرت في توجهي، بل وفي توجه تجارة الوالد رحمه الله على نحو ما ستتضمنه الصفحات القادمة .