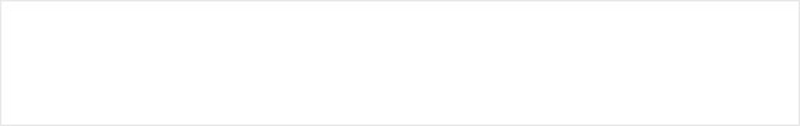المدينة المنورة – المحرر
كانت لحظة الشوق وحوافز الحنين هي ما يسكن النفس اللحظة.. ذلك الشوق لتلك الفضاءات المغروسة في “اطلال” الماضي الذي انداح من بين اعيننا في لحظة فارطة كأنها الآن بالتمام فاصبحنا نحن اليه.. نحن الى تلك الملامح لتلك الشخوص الذين ملأوا ذاكرتنا بوجوههم الطيبة وازكموا انوفنا برائحتهم الطافحة الجميلة من عرق اجسادهم الفتية.
هكذا بعثرت في اوراقي القديمة لاجد هذا الوجد المتبادل بين ذلك الشاب الضاج في صمته زاهر عثمان – وذلك – اليعسوب – الذي رحل عنا فجأة بلا مقدمات تعطينا مزيداً من الوقت لتملأ نفوسنا منه اعني محمد صادق دياب وهما يتحاوران في معشوقتهما تلك الحبيبة الخضراء.
كنت أفتش قبل فترة في مجموعة صوري القديمة..توقفت لثوانٍ أمام بعض الصور للمدينة المنورة (وهو الاسم الذي يتشرف بها منذ قرون.. قبل أن يظهر من يقترح اسما جديدا هو “المدينة النبوية”) ليست ثم وضعتها جانبا..ثم انتفضت مشاعراً.. ياااه.. لم يبق شيء تقريبا مما ظنَّته ذاكرتي حاضرا.. المكتبة المحمودية، مكتبة عارف حكمت، دار أبي أيوب الأنصاري، مدرسة العلوم الشرعية، شارع سعود…و..و.. ما كان لابد من إزالة بعضه لتوسعة المسجد النبوي الشريف.. وبعض آخر كانت إزالته عبثاً ناتجاً عن غياب الرؤية لأهمية تلك المعالم كجزءٍ متصل بتاريخ المدينة المنورة العبق..
مما تبقَّى وأبقى..:
كان شارع العينية أهم شوارع المدينة القديمة.. ما زلت أذكر أن جانبه الغربي كان ينتهي إلى مجموعة من الأسواق منها سوق البرسيم وزقاق القفاصة الذي كان على جانبه الشرقي بيت عبد الله بن عبد المطلب، أبو النبي صلى الله عليه وسلم..من نهاية الشارع كان يمكن الوصول إلى أسواق الحبابة والطباخة ومدخل سويقة من باب المصري.. كان باب المصري آخر بوابات المدينة.. يظل بذهني متعلقا أكثر لأن الجندي الذي كان عليه رأى أن يُهذِّب براءة طفولةٍ محدودة بصفعةٍ لا تزال ترن في أذني اليمنى حتى الآن.. هو من القليل الذين لم أستطع أن أسامحهم في نفسي..رغم مرور الزمن.. السبب الآخر لذكرى باب المصري هو ما يكاد يكون طرفة.. ففي خضم المنافسة بين المدن وكانت جدة قد سبقت إلى إعادة بناء بواباتها.. أعلن أمين المدينة المنورة حينذاك عن عزم الأمانة إعادة بناء جميع بوابات المدينة القديمة.. تم نشر الخبر في نفس اليوم الذي كان فيه باب المصري يودَّع التاريخ إلى الأبد.
لنعد إلى شارع العينية.. كان كما قلت متميزا في سعته ونمطه.. على جانبيه رواقان بأقواس مستديرة.. كنت أستغرب من أنه رغم وجاهته لم تكن هنالك واجهات للمباني تطل عليه مباشرة..وظل ذلك التساؤل سنينا حتى وجدت الإجابة عليه صدفة..من العم محمد علي ياسين، رحمه الله، أحد أبرز رجالات المدينة.. قال أن شارع العينية كان إضافة في العهد العثماني المتأخر.. أراد فخري باشا والي المدينة أن يضيف إليها شكلا حضاريا جديدا على غرار شارع الشانزليزيه..فتم شق الطريق وسط النسيج العمراني المترابط..كانت هنالك آراء أخرى ترى مثلا أن الشارع شُقَّ لتسهيل وصول أجهزة الدفاع إلى قرب المسجد النبوي خلال ما يُسمى بسفر برلك..ذلك الذي هجَّر الكثير من أهل المدينة إلى غير عودة..أذكر من والدتي بيتين لأعرابي كانت تستحضرهما دائما ممزوجة بذكرى أليمة:
يــا الله أسألك القبــول
لاهــل المدينــة العالية
فخري يسفر في الضـعوف
خلَّى المنـازل خاليـــة
رحم الله عزيز ضياء فقد خلد في ثلاثيته الرائعة “قصتي في زمن الجوع والحب والحرب” بعضا من مآسي ذلك السفر..ولعلها مأساة أخرى أن تلك الثلاثية التي لا تقل روعة عن أيام طه حسين، لم تلق ما تستحقه من وفاء.. هي دعوة هنا للمنتمين إلى نادي القصة أن يضعوا شيئا عنها..يليق بها..
سأحاول السير في الشارع من غربه إلى شرقه حيث ساحة باب السلام..ألتقط ما ينقض فجأة من الذكريات.. على الجانب الأيسر كان الخزرجي كاتب العرائض يملأ المنطقة طُرفا وصخبا.. وبعده بقليل كان هنالك دكان العم محمد علي كردي، رحمه الله.. كان بعضا من نور يفتر عن ابتسامة لا تنسى ملامحها.. كان الشارع مزيجا من محلاتٍ مختلفة الأحجام والبضائع.. والخدمات.. على الجانب الأيسر كانت هنالك الكثير من محال الملابس والأحذية.. وكانت هناك مكتبة ضياء.. كانت هي الوحيدة التي تبيع الصحف والمجلات وبعض القرطاسية.. لم أكن أطيق صاحبها، زين العابدين ضياء، رحمه الله.. الذي لم أره يبتسم أو يتصنع الابتسام..وكنت أضيق به حين يبيع الجريدة التي تحمل أسماء الناجحين بريال بدلا من سعرها الرسمي وقتها (4 قروش).. ومع ذلك فقد كانت مكتبته شيئا من مصادر الثقافة.. كان مقابلها على الجانب الأيسر محل أو كما كان يطلق عليه معرض للأدوات الكهربائية هو معرض العامر..وما زلت أذكر كيف كان الناس يلتمون عند واجهته لرؤية ذلك الجهاز الغريب المسمى “تلفزيون” وشاشته لا تُظهر شيئا عدا نقط بيضاء وسوداء في انتظار البث..الذي جاء بعد شهور..كانت تلك بداية العامر الذي انتقل تدريجيا إلى المفروشات تاركا الأدوات الكهربائية لمدير المحل وقتها أحمد جبلاوي..
كانت أهم نقطتين لي في الشارع محل البخاري الذي يبيع اليغمش والمنتو في الجانب الأيسر.. لم أذق حتى اليوم مثل ما كان يصنع..والمحل الآخر كان على الجانب الأيمن في نهاية الشارع قرب الدرج المؤدي للساحة.. كان محل التركي الذي كان يصنع آيسكريما خرافيا ذاع صيته حتى طبَّق الحجاز..وكان إحدى المزارات الحتمية.. كان يصنعه بنكهات متعددة ولكن الحليبي كان الأرقى.. عندما هدم الشارع انتقل بمحله إلى شارع قباء النازل.. بقي لأشهر.. ثم اختفى تماما..ولم يظهر مثل آيسكريمه حتى الآن.. كان في الشارع أيضا محل الخطاط التركي الذي كان يفخر بالإشارة أنه خطاط الحرم النبوي..وكان يصنع منتجات تذكارية انتهت بانتهاء الشارع.. كانت أسوأ النقاط محلا بعد محل التركي فيه عجوز يبيع الساعات..كانت هواياته التحرش بالنساء والصبيان كلاما ولمسا..ما استطاع.. سامحه الله وسامحنا..
هل هذا كل شارع العينية.. بالطبع لا.. ولكن هذا ما استقر منه على الورق الآن.. انزلوا معي بعض الدرج إلى ساحة باب السلام.. دعوني أذكر هنا أن القبة الخضراء كانت هي متلقى عين السائر في اتجاه الحرم في شارع العينية.. ساحة باب السلام كانت الساحة الرئيسية على جانبيها الشمالي والغربي كانت بعض المكتبات..كان أبرزها وأكبرها مكتبة عبد المحسن اليماني، رحمه الله، وبعدها مكتبة النمنكاني وأحمد حمود وغيرها.. أما بقية المحلات فكانت للساعات والمجوهرات.. كانت الساحة مليئة بالأنشطة وبالباعة المتجولين.. المنفوش..الزلابية..وكان هنالك يمني مهذب الهندام والحديث..أنيق العرض لبضاعته التي كانت “اللبنية” أيضا كانت رائعة بمذاق ذلك الزمن..
ذات يوم خرجت مع والدي، رحمه الله، من باب السلام في شهر رمضان.. كان هنالك ازدحام غير مسبوق في الساحة..وقليلا قليلا.. تعالت الهمسات حتى عرفت أن قِصاصاً يجري في جانب الساحة الجنوبي..فزعت وأن ابن ثمان سنين من مجرد الخبر.. ويبدو أن خروجنا من الحرم كان متأخرا، كعادة والدي، رحمه الله، بالتسنن الطويل بعد الصلاة وزيارة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام..ولهذا فما كان من ازدحام هو بعد انقضاء الأمر.. وفجأة وجدت نفسي أمام بقعة كبيرة من الدم..حولها عدد من الجنود يبعدون بعض النسوة اللاتي كُنَّ يحاولن الاقتراب.. عرفت فيما بعد أن لدى البعض اعتقاد أن العاقر التي تقفز فوق دم قتيلٍ تنحل عقدتها.. المهم دارت بي الدنيا لمنظر الدم.. ووبخني أبي على ضعفي كرجل..”كيف لو رأيت القصاص؟!!”.. كانت إشارته تلك وسيلة لشد عزمي.. إذ أعلم أنه كان أرق مني قلبا.. رجعت إلى البيت واستفرغت ما كان في جوفي من بقايا السحور..واستحضرت تخيلات رهيبة لتلك الحادثة.. لا زالت القصة تحزنني إذ عرفا فيما بعد أن القاتل، رحمه الله، قتل امرأة عجوز لسلب مالها..وتم التعرف عليه من هويته التي سقطت مكان الحادث.. بقي في السجن بضع سنين حفظ فيه القرآن كاملا..وحين بلغ القُصَّر السن القانوني طالبوا بالقصاص..فتم.. تمنيت أنهم سامحوه..ورأيت أن ما لقيه من عقاب السجن وما ألقاه عليه من توبة يغني..عن العقاب المزدوج..ولكنها الحياة في القصاص..
هكذا جاءت هذه الخواطر دون تعمد استثارة..وأسفت أنها جاءت بما كانت عليه من نهاية.. كنت أريدها أكثر بهجة..وهنا خطر ببالي صوت الأذان.. كم كان جميلا وأنت تستمع إلى تتابع المؤذنين بأصواتهم السماوية بدءا من المئذنة الرئيسية.. وكم هو مؤسف أن خضعنا لبعض الآفاق الضيقة التي أوقفت ذلك..
في صيف عام 1395هـ..كنت أنظر من نافذة بيتنا باتجاه الحرم..وكانت هناك سحب سوداء تكاد تخفي صورة القبة الخضراء.. كان ذلك حريق سويقة.. الذي كان بداية النهاية للمدينة القديمة.. هل قلت سويقة.. ربما أعود يوما لها ولحارة الأغوات وربما يفعل ذلك من هو أصح مني ذاكرة..
زاهر عثمان
إيوا كدا يا دكتووور زاهر .. منُو
أنت هنا لا تنبش ذاكرتك وحدك ولكنك أثرت عطر الزمن فى ذاكرة الجميع..
لقد مشيت معك خطوة بخطوة من أسواق البرسيم والحبابة والطباخة وزقاق القفاصة، ووقفت معك عند الخزرجي “العرضحالجي” والعبارة الشهيرة :”إن سألتم عنا فنحن بخير لا ينقصنا سوى مشاهدتكم” ، وكذلك دكان الكردي، ومكتبة ضياء وبائع الآيسكريم والسحلب ، وذكرتني بالخطاط التركي وقطع القماش الخضراء التي طرز عليها بعض الآيات كي يبيعها للزوار، حتى بائع الساعات العجوز أكاد أجلب صورته إلى الذاكرة، وأتذكر أن هناك خرازا مدنيا أنيقا يصنع “المدس المقصبة”، ومن علامات ذهابنا إلى المدينة آنذاك أن يعود أحدنا وهو يمتطي في قدمه مداسا مقصبا من صناعة ذلك الخراز، وفي إصبعه خاتما من عقيق..
كنا يازاهر حينما نأتي في الرجبية للزيارة نبقى شهرا كاملا والمدارس على أيامنا كانت تساهيل، خلال الشهر كنا نتحول إلى مدائنة نشارك أندادنا لعب الكرة وبعض الهوشات ، وكان لي من طلبة المدرسة الفهدية التي كانت في باب المجيدي أصدقاء وأحباب لا زلت أذكر اسماء بعضهم : عبد العزيز حافظ ، هاشم شيحة، بن دامه، الخطار،عاشور ، التوان “بوشكاش” ، ومنسي “المزور” في الحرم.. كنت ألعب مع بعضهم الكرة عصرا في فريق كان له حضوره آنذاك يسمى بورسعيد، وكنت أشارك في مباريات أشباله أمام أحد والعقيق، وفي المساء كنا نتشارك في شراء تلقيمة شاي وقرطاس سكر نذهب به إلى قهوة عم أحمد طيرة قرب البقيع لندفع له ثمن الماء الساخن فقط .
يااااه يا زاهر كم كنا نأخذها جلانكاكي من باب المجيدي إلى قباء “راوند ترب” ، أو سيدنا حمزة.. وكان “ركب” المكاكوة في الرجبية مهرجان فرح في المناخة فتراهم بالغباني على رؤوسهم والبقش الكشميري في أوساطهم ، يتوزعون على مراكيز القهاوي هناك لتتعالى في البرحة أدوار “الصهبة” ، وكأني استمع الآن إلى الحادي عم عبد العزيز محضر وهو ينقر على طربيزة المقهى ويطلق لصوته العنان:
“جل الذي أنشأ الأفراح
وانعم على المؤمنين بالنور”
ذكريات كثيرة يا رجل تتصاعد الأن إلى نافوخي منها ذكرى البيت المسكون الذي سكناه، والذي يؤكد صاحبه علينا بأن لا نخاف، فالبيت لا يشاركنا السكن فيه سوى مجموعة من الجن الصالحين، “فلا عليكم إن شاهدتم أحدهم يتوضأ أو يستخدم بعض أواني النحاس”!!
اهطل يا رجل كم كانت البداية رائعة.. مر بنا على سويقة والباب المصري وزقاق صيادة، وبرحة المناخة، وزقاق الطيار وأرض محبة..
أشعل فتيل الحكايا لدى شاكيرا وابن المدينة وليانا، أكاد أراهم الآن يبحلقون في مرايا الذاكرة ليرصدوا عمرهم هناك..
أحلم أن تكتبوا المدينة التي في القلب فثمة أناس سيفرحهم أن يستعيدوا معكم تلك المدينة من ركاب الزمن..
دمتم جميعا بخير ..
أكمل يا زاهر.. ها نحن نتحلق حولك.
محمد صادق دياب