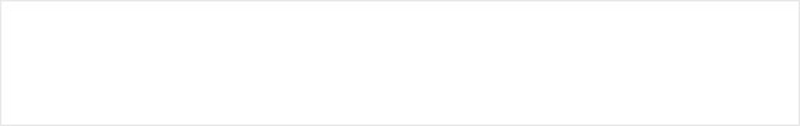المؤسسة التعليمية والآمال العريضة
مع بداية كل عام دراسي، تتسع دائرة الآمال العريضة، من أجل مستقبل أبناء الوطن بتحقيقهم إنجازات علمية متقدمة، هي الأمل بعد الله بوصولنا لنقلة نوعية، أزعم أنها الأساس لبناء نهضة حضارية ينشدها المجتمع، فدول العالم المتقدم تُدين لمؤسسات التعليم بالكثير من الفضل، وتقيس مستقبل التنمية بنجاح المؤسسة التعليمية، والقائمون عليها باعتبارهم أساس البناء المعرفي، لهذا كان التوجه نحو المدرسة الذكية، بأبعادها ومتطلباتها، التي يُمكنها تهيئة الظروف المحيطة بها، ومدى قدرة الطلاب والطالبات، على التكيُّف مع هذه المعطيات، والطريقة المُثلى لكيفية إدارة الوقت بطريقة أكثر انتظاما بغرض الاستفادة، ويتبادر لأذهاننا تساؤلات عدة، تنصب في دور المخطط والجهات التنفيذية، عن مدى إجراء تعديل في البرنامج الدراسي اليومي، فيما يتعلق بطلاب وطالبات التعليم العام، وعلى وجهة التحديد المرحلة الثانوية.
حين تتاح الفرصة لطلاب وطالبات هذه المرحلة، ولتكن تجربة افتراضية، يقاس مدى نجاحها من عدمه، على قرار النظام الجامعي بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، يتمكن الطلاب والطالبات من الحضور للمدرسة، ويستثمر بقية اليومين الآخرين، في تلقي دروس مبرمجة، لكافة التخصصات عن طريق تجربة المدرسة الذكية، مع تقسيم الطلاب والطالبات إلى مجموعات، بمعنى أن المدرسة بكامل أطقمها من المعلمين والمعلمات ، متواجدون على مدار أيام الأسبوع العملية، بحضور مجموعة طلاب وطالبات المواد العلمية، أيام (الأحد والثلاثاء والخميس)، وبقية التخصصات الأخرى، أيام (الإثنين والثلاثاء والخميس)، مع ملاحظة أن اليوم الثالث من أيام الأسبوع (الثلاثاء)، يكون يوما مفتوحا لجميع المجموعات، تقام فيه الأنشطة الطلابية والمحاضرات التثقيفية، إلى جانب عمليات التقويم المستمرة، التي يتطلبها كل تخصص من التخصصات التعليمية.
بما فيها المحاضرات التي تُلقى عليهم، عبر شبكة الانترنت، ودائرة البث المباشر، كي تعطي مؤشر لمدى نجاح التجربة الافتراضية، لزرع الثقة لدى الطلاب والطالبات، وليتعوّدوا الاعتماد على النفس، وتُتاح فرصة المحافظة على سلامة ونظافة البيئة المدرسية، ولنخفف على هذه الشريحة العُمرية ، ما تواجهه من ضغوط نفسية من كلا الجنسين ، غالبا ما تواكب مرحلة المراهقة وحاجاتها الخاصة، التي قد لا تتمكن المدرسة من تحقيقها، في ظل ضغوط خارجة عن إرادتها، يأتي في مقدمتها حجم المناهج ، التي تعتمد على الكم وتُنفذ وفق خطة زمنية محددة بمعطيات يحترمها الجميع، بينما تتطلب معايير الجودة، على تركيز الجهة المشرفة على النّوعية باعتبارها الأبرز، وهنا تظهر مهارة المنفذ من المعلمين والمعلمات، كما تبرز بذات الوقت مهارات الابداع والتفوق لدى الطلاب والطالبات.
ثمة خلاف قد ينشأ من خلال هذا الطرح، ويختلف معي البعض فيما ذهبت إليه، وبدوري احترم أدب الاختلاف، وصولا لقناعات معينة وإن تباينت الأفكار، ولضمان نجاح تجربة المدرسة الذكية، يمكن تطبيقها على عدد محدود من مدارس المملكة، في مدن معينة لشريحة سكانية يتوفر فيها القدر الأوفر من الوعي الثقافي، والانضباط الأسري والتوجيه الفاعل والمتابعة المستمرة، خصوصا إذا كان الأبوين تلقيا تعليمهما ودراساتهما العُليا، بدول متقدمة وعوّدا أبناؤهما على نموذج متميز من التربية، لا تقبل الارتجال وإهدار الوقت وتتمتع بسلوكيات وسمات حضارية عالية، ولا أعنى التقليل من شأن ومكانة بقية أفراد المجتمع، ولكن الواقع يُؤكد لنا وجود الفروقات الفردية، لأؤكد توافق مجتمعنا بكل أطيافه وبسطاه، على تأييدهم لكل جديد، مع المحافظة على الثوابت، ونحن أمام رؤية المملكة 2030، فإن المرحلة القادمة تتطلب إعداد جيلا أكثر طموحا للمشاركة في جوانب التنمية، اعتمادا على كوادرنا الوطنية، فحريٌ بنا أن نأخذ بأيدي هذه النماذج المبدعة، بما يعزز دورهم في مستقبل الوطن.
التصنيف: