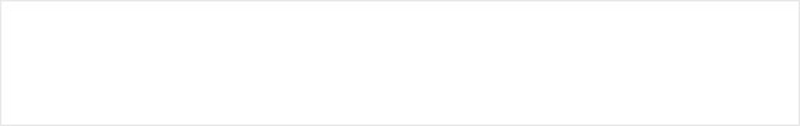مكة المكرمة-المدينة المنورة -واس- البلاد
أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس, المسلمين بتقوى الله ذلك أن التقوى مثابة لغفران زلات النفس وخطاياها وصلاحها في دينها ودنياها.
وأكد الشيخ السديس في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس أن سماحة الإسلام ليست ضَعْفًا أو اسْتِكانة، ولَا ولَنْ تكونَ مَطِيَّةً لاحتلال أرضه أو استباحَةِ حُرُمَاته، وإنَّ أَرْوَاحَنَا لرخيصة أمام مُقَدَّسات الإسلام وصيانة حُرُمَاتِه، وإن البادئ بالعدوان لهو الإرهابي الحقيقي، وليس إرهابيا مَنْ دَافَعَ عن أرضه وعِرْضِهِ ومقدساته، وإن قضية المسلمين الكبرى في هذا الزمان هي قضية المسجد الأقصى الأسير، والقدس العربية الإسلامية، والتي ستظل إلى أبد الآبدين عربيةً إسلاميةً مهما عاند المعاند أو كَابَرَ المكابر، وَلْيَعْلَم الناسُ جميعًا أنه لا يَصْلُحُ العَالَم إلا إذا كانت العدالة ميزان العلاقات الإنسانية في كل أحوالها فلا يبغي أحدٌ على أحد، ولا يُهْضَم حَقُ أحدٍ لأجل آخر، فسماحة الإسلام لا تنافي الحزم والعزم خاصة في الحفاظ على المقدسات، وكذا في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومواجهة التطرف والإرهاب، وخطر المخدرات والمُسْكِرات، والتصدي بحزم للافتراءات والشائعات عبر المواقع والشبكات، ومحاولات إسقاط الرموز والنَّيْل من ذوي الهيئات والمقامات من أفراد ومؤسسات، والإخلال بالأمن ونشر الفوضى والحطّ من الأقدار والكرامات، وشق عصا الجماعة ، فإن فئاما من الناس فهمت السماحة سماجة، والاعتدال انحلالا ، فتنصلت من الواجبات، ونالت من المُسَلَّمَات، وتفلتت من القطعيات، وتكالبت على تلفيق الفتاوَى والأخذ بالرُّخص في غير مواضعها مُتعللين بالسماحة واليُسر، لافتا النظر الى أن من فضل الله تعالى على بلادنا -بلاد الحرمين الشريفين- أن جعلها بلاد التسامح والاعتدال، ورائدة الحزم والعزم ، فجمعت بفضل الله سوامق الخير وذوائب الشرف والفخر، ولا تزال بالخيرات مُسَوَّرة، وبالبركات مُنَوَّرة.
وفي المدينة المنورة شدّد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم على أهمية حسن ظنّ العبد بخالقه سبحانه, الذي بيده كل شيء, رزقه وصلاح أمره كله, مؤكداً أن من ثمار الإيمان بأسماء الله وصفاته حسن الظنّ به جلّ وعلا, والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه.
وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس : إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة منها والباطنة, ودخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح, فالدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل المقصود والأعمال الظاهرة تبع ومتمة, ولا تكن صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب, فهو روح العبادة ولبّها, وإذا خلت الأعمال الظاهرة منه كانت كالجسد الموات بلا روح, وبصلاح القلب صلاح الجسد كله, قال عليه الصلاة والسلام : ( ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب) متفق عليه.
وأضاف أن من آكد أعمال القلوب حسن الظنّ بالله فهو من فروض الإسلام وأحد حقوق التوحيد وواجباته, ومعناه الجامع كل ظنّ يليق بكمال ذات الله سبحانه وأسمائه وصفاته, فحسن الظن بالله تعالى فرع عن العلم به ومعرفته, ومبنى حسن الظنّ على العلم بسعة رحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره, فإذا تمّ العلم بذلك أثمر للعبد حسن الظنّ بربه ولا بد, وقد ينشأ حسن الظنّ من مشاهدة بعض أسماء الله وصفاته, ومن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظنّ ما يناسب كل اسم وصفة لأن كل صفة لها عبودية خاصة, وحسن ظن خاص بها.
وتابع إمام وخطيب المسجد النبوي يقول : إن كمال الله وجلاله وجماله وأفضاله على خلقه موجب حسن الظنّ به جلّ وعلا, وبذلك أمر الله عباده, إذ قال سبحانه :” وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ” وقال سفيان الثوري رحمه الله : (أحسنوا الظنّ بالله), وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته على ذلك لعظيم قدره, قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام, يقول : (لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بالله عزّ وجل). رواه مسلم
وأوضح الشيخ عبدالمحسن القاسم أن الله جلا وعلا امتدح عباده الخاشعين بحسن ظنّهم به, وجعل من عاجل البشرى لهم تيسير العبادة عليهم وجعلها عوناً لهم, فقال تعالى : ” وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ “.
وذكر فضيلته ثمرة حسن الظنّ بالله في العديد من المواقف, مشيراً إلى سيّر الرسل عليهم السلام الذين نالوا المنزلة الرفيعة في معرفتهم بالله ففوّضوا أمورهم إليه حسن ظنٍ منهم بربهم, فإبراهيم عليه السلام هاجر عند البيت وليس بمكة يومئذٍ أحدٌ, وليس بها ماء ثمّ ولّى إبراهيم منطلقاً فتبعته وقالت” يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي, الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً, وجعل لا يلتفت إليها, فقال له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال, نعم, قالت : إذاً لا يضيعنا” رواه البخاري , فكان عاقبة حسن ظنها بالله ما كان, فنبع ماء مبارك, وعمر البيت, وبقي ذكرها خالداً, وصار إسماعيل نبياً, ومن ذريته خاتم الأنبياء وإمام المرسلين.
وأفاد أن بني إسرائيل لحقهم من الأذى ما لا يطيقون, ومن عظم الكرب يبقى حسن الظنّ بالله فيه الأمل والمخرج, فقال موسى عليه السلام لقومه “اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ “.
واشتد الخطب بموسى عليه السلام ومن معه, فالبحر أمامهم وفرعون وجنده من ورائهم وحينها” قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ” فكان الجواب من النبي الكليم شاهداً بعظيم ثقته بالله وحسن ظنّه بالرب القدير, ” قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ “, فأتى الوحي بما لا يخطر على بال, ” فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِين ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ “.
إمام وخطيب المسجد الحرام: قضية المسلمين الكبرى هي المسجد الأقصى والقدس العربية