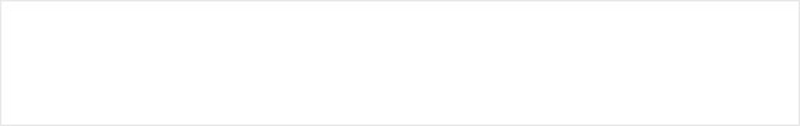يعدها : علي محمد الحسون
•• ما أن أغيب – لأيام – ولا اقول “لشهور” وأعود الى هذه المدينة الحبيبة – المدينة المنورة – بنور المدفون فيها إلا وأجدني تائهاً في شوارعها وأحيائها.. والتي انتقلت الى أماكن ما كنت أحسب في يوم من الأيام أن تتحول الى أحياء لبعدها الكبير.. وجد أولئك – الأهل – الذين كانوا وهم داخل بيوتهم يسمعون “خرفشة” مكرفون أولئك “المؤذنين” وهم يتأكدون من صلاحيتها قبل أن يرفعوا صوت الاذان وجدوا أنفسهم محرومين من تلك “الخرفشة”
نعم لقد بعدت بهم الشقة وأي بعاد هذا لم يعد في مقدورهم اللحاق بالامام قبل أن يرفع صوته بتكبيرة الاحرام التي كانوا لا يغيبون عنها وهم يسيرون على أقدامهم من تلك البيوت المحيطة بالمسجد النبوي الشريف.
لقد تفتت تلك الأحياء وتباعدت تلك “المشاوير” وأصبح كل شيء أمامك ليس له تلك الميزة التي كانت في داخلك وأنت تخطوا في تلك الأزقة ورائحة – العطارة – تشق انفك.. أو رائحة الكير من دكاكين الصاغة آل الفضل في سويقة أو رائحة “البن” النافذة من مقهى – عم صالح – المغربي أمام المحكمة الشرعية في بداية حي الساحة.. وبذلك الجزار بجانبه بثوبه – اللاس – واقفاً في أناقة أمام “دكانه” ممسكاً بسكينة يقطع أوصال اللحم في حرفية ظاهرة أو حتى بائع النعناع على جنب الشارع المرصوف بالحجارة التي يرشه في تكاملية حبيبة أمام منزله العم عبدالله طاسجي.
***
كانت – المدينة – باحيائها المتلاصقة وبأزقتها المتعرجة ودكاكينها تنظر الآن متسائلاً أين هي فيتملكك العجب هل هذه المساحة حول المسجد النبوي الشريف بهذه الميادين هي التي كانت تضم كل تلك الأحياء بشوارعها وحوانيتها ودكاكينها وبحركة الناس فيها.
يزداد عندك الحنين لذلك الشارع – العجيب – في بنيانه بتقدماته أو بروزاته وبتلك الأنواع المتعددة فهذا – التركي بائع – الأسكريم – أو عم حجي عابد ورائحة – اليغمش – التي تفوح على كل الشارع والذي ليس له مثيل الآن بجانبه ذلك الخياط أو علي شاهين ذلك الرجل الأنيق في – خرازته – في الطرف الآخر هذا عم عيسىى المشهدي في دكانه وهو يتعامل مع مبتاعي القماش منه بأريحية مفرطة أو في طرف الشارع هناك دكان أحمد رشوان الذي يتعامل بروح العطاء مع الآخر أو أولئك عائلة – المصرية – بما يقدموه من أكلات شعبية من زلبيا أو مقلي لا ينافسهم إلا رائحة “الكباب” من “الهابوبي” أمام مسجد فاطمة الموصل الى سوق الحبابة.
***
نسأل أين ذهب هؤلاء.. بل أين ذهب بادرب ذلك العطار الذي تقف أمامه ليعطيك ما تحتاجه من “دواء” شعبي ما أن تتناوله حتى يذهب ما بك من ألم.. هذا سوق باب المصري بكل أطيافه.. فهذه دكان عم حسين أبو الفرج وأمامه دكان الخريجي أو ذلك القطان أو القباني او بائعي الجبن والزيتون كلهم هنا.. أما بائعو العيش الحب أو الشريك بأنواعه أبو السمسم أو ابو السمن.. فتحضر أمامك صورة عم محمد صلاح أو عم بادي كعكي بصورته الهادئة أو عم عبدالله بري – أو أبو طربوش.
***
تدخل الى سوق الطباخة وهناك تختلط في أنفك – رائحة – الرؤوس المندي عند عبدالمطلوب أو رائحة الكبدة عند علي موسى.. أو شكل – الصجك – بلونه المايل الى الاصفرار كأنه من مدهون بالزعفران عند – قفارا – أو محمود السيسي ذلك السوق العجيب وأمامه على المدخل الآخر يوجد ذلك الشاب النشط بائع التمور “يوسف حيدري” الذي لم يفرط في مهنته حتى اللحظة أو عم شحات عبدالله ذلك الرجل النقي وهو يبيع لك السمبوسكوا لجبنية في نظافة مبهرة.
ياه.. تسأل مجدداً أين ذهبت تلك الأسواق وأولئك الناس فلا تجد اجابة مقنعة إلا هذه الكلمة هي الأيام دواليك والدنيا أغيار.
***
لا أكتمكم.. لقد تهت لدقائق وأنا أسير في أحد الأحياء الجديدة.. لم أعرف أين أنا حتى سألت سائق تاكسي والمؤلم أنه ليس من أهل – المدينة – فدلني على الطريق الصحيح بلهجته التي لا يخطئها سمع انه من بلدي آسيوي.. فبقدر سعادتي بارشاده لي بقدر ما سعدت أني وجدت “تاكسي” في هذه المدينة المحرومة من التكاسي الدوارة فقلت في نفسي أجنبي أجني المهم وجدت تاكسي.
إنها سياحة في بعض الأحياء ونبش في ذكريات تلك المدينة التي عرفناها وتشبعنا بأريج عطرها وبفاغيتها ووردها وفلها وبدوشها النافذ حتى النخاع.
إنها المدينة التي افتقدناها.