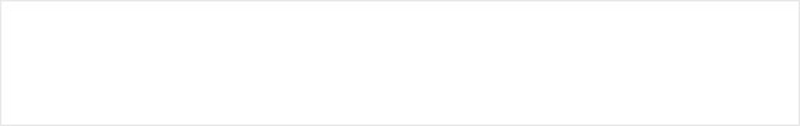فتنة الشكل والمجموعة الثمانينية:
الفترة التي لامست فيها القصيدة الحديثة في الفصحى، أصابعَ بعضِ شعراء العاميةِ في الثمانينيات، كانت الذات الشعرية العامة في نصوصِ تلك الفترةِ، وهي نصوصٌ هائلةُ العددِ، تتمسكُ فنياً بالصياغةِ الموروثةِ في تشكيلِ القولِ الشعري على اعتبار أن القالَبَ المؤسِّسَ قال كلمتَهُ النهائيةَ في موضوعِ الشكلِ، حسب الزعم التراكمي الطويل للعمودية. أما موضوعياً، فقد كانت الذات الشعرية تلك، تمثل رأيَ الأغلبيةِ الطاغيةِ من شعراء النص العمودي حول السيرِ على منوال الفكر العامي في طرق موضوعاته الأثيرة، وطرح همومه المعتادة.وعندما جاءت مجموعة الفترة الثمانينية، وهي مجموعة قليلة العدد جداً بالمناسبة، طرحت حكايةَ الإيمانِ بالقالبِ المؤسس جانباً،
وذلك على الأقل من جهة التشكيك في جدوى الصياغة نفسها. التشكيكُ في مواءمتها للتعبير عما فرضته معطيات الواقع الحديث على أكثر من مستوى، والتشكيك في رهان مؤيديها على قابليتها لاستيعاب ما أفرزته الحياة المعاصرة من هموم جديدة،
ومن توتراتٍ ذهنيةٍ محدَثةٍ أنتجتها شدة الالتحام الإنساني بالواقع الذي يعيشه الفرد من جانبين. الجانب الذاتي الذي تبدلت فيه أشياء كثيرة جراء تأثره بتحولات الخارج، وهي تحولات هائلة التأثير من نواح عديدة، والجانب الواقعي العام، حيث بددتِ التقنيةُ الحديثةُ جهلَ الإنسانِ بكثيرٍ من وجوه الحياةِ، وأسرار الطبيعةِ، وكشفت له محدثاتُ العلم واختراعاتهُ الضخمةُ العديدَ من ألغاز الكون، وصمتِ الفضاء، حتى أصبحت النظرةُ إلى القمر الذي كان رمزاً للجمال والوضاءة في المخيال العربي، مثلَ النظرةِ إلى جبلٍ في الصحراء، قبيحٍ، ومشوهٍ، وأجرد.
هذا التشكيك المبرر من ناحية فنية ثقافية، لم يغامر كثيراً في الذهاب إلى العمق، بل أحدث فتنتَه اللغويةَ في حيز المفردة تحديداً، وغالباً من دون وعي رؤيوي، ولعب من ثم على هذه الثقوبِ الصغيرةِ في جسدِ القصيدة العامية مدفوعاً بتأثره باللعبة نفسها في القصيدة الفصيحة.أوقدت هذه الفتنةُ الشكليةُ وجهَ النصِ، على الأقل جمالياً، لكن العمقَ الذي كان المستهدفَ الرئيسَ، في نظر تلك المجموعة بقي على حاله معظمَ الوقت، باستثناء اختراقاتٍ نادرةٍ قياساً إلى كم المحاولات الكثيرة التي افتعلتها المجموعة سواءً في عز حضورها الثمانيني، أو على امتداد السنين العشرين الأخيرة من االقرن الماضي.توقُفُ المجموعةِ عند الاشتغال على أفق الكلمة فحسب، يرجع في الواقع إلى أسباب عدة،
من أبرزها تمكن التلقائية الشفاهية الساكنة من كلام الشاعر بحيث لم يكن في مقدوره الخروج من معجمها إلا بمكابدة لغوية تجترحها ذهنية مقصودة في إطار وعي الشاعر بأهمية التغيير. ومن أبرز الأسباب أيضاً، وقوعه في سياق ثقافي عامٍ معزولٍ، أو تم عزله، عن التطورات النوعية التي مر بها الشعر الحديث في شقه الفصيح، وكذلك في بقية الفنون والآداب الحديثة.
لم يحدث الفارق المنشود:
بعد هذا كله، ووقوفاً على هذه اللحظة الماثلة، ما تزال الذات الشعريةُ التقليديةُ لا تجادلُ في تمسكها اليقيني بالقالبِ النموذجي القديم. وفي المقابل، ما تزال تنقضُ الذائقةُ الجديدةُ ذلك اليقينَ باجتهاداتٍ فنيةٍ تارةً، واجتراحاتٍ فنية وموضوعية تارة أخرى، من هذا الشاعر حيناً، ومن ذاك الشاعر حيناً آخر، غير أن المسافة من الطرف الأول بقيت على حالها تقريباً من جهة الطرف الثاني،
حيث لم يتمكن الأخيرُ(إلا في حالات قليلة ومتباعدة) من تدشين انقلاب مفصلي على النص القديم، كما حدث في فضاء القصيدة الفصيحة، إذ لم يعد غريباً في المشهد الشعري الفصيح بروزُ الشكل الشعري المختلف في إيقاعه ولغته وتحولاته عن الشكل الكلاسيكي، بل أصبح شعر التفعيلة في فترة من الفترات الخيارَ الأكثر جاذبية لكثير من الشعراء، ثم لما جاءت قصيدة النثر، شكلت بدورها اختلافها عما سبقها من أشكال، وحشدت أصواتها، واتخذت طابعها المغاير في النظر إلى أشياء الحياة، ورؤية الواقع.
من تلك المجموعة، لم يصل إلا القليل من الشعر الجيد، لكن الرغبة القوية في إحداث فارق فني، ومراودة موضوعية جديدة، وصلت لشعراء من أجيال لاحقة. شعراء أصغر سناً، ولكنهم أكثر تعافياً من سلطة المثال الشعري الذي هجست به الإرهاصات الشعرية الثمانينية. فلئن كانت وقعت تلك الزمرة في حدة النبذ الفني الذي كانت تمارسه على القصيدة العمودية الأفقية،
ولئن أهدرت جُلَ وقتها في التبشير بمثالها الشعري من دون أن تحيله إلى واقع معتبر في حقيقة الأمر، فإن المبدع في ما تلاها من أجيال راود النصَ الجديدَ مراودةَ الشاعرِ الكاشف الباحث عن ضوئه المخبوء في الكلمات، عما هو معني به، وما هو متعلق بعالمه وزمنه، ولم يشغل وقته بقراءة مجادلات من سبقه حيال قديم وجديد، وتقليدي وحديث، إلى آخر التوصيفات التي كان بعضها مفتعلاً لكسب الشد الجماهيري.
نعم، قرأ الشعراء الشبان اللاحقون النصوصَ الجيدةَ المكتوبة في تلك الفترة، وعرفوا منها قيمةَ شعرائها الفنية، ولعلهم رصدوا من قرب رؤيةَ كلِ شاعرٍ منهم على حدة، لكن تظل لكل جيلٍ شكوكُه الفنية، وارتياباته الذوقية تجاه من سبقه، وهذا الحذر مهم في نظري، إنه أحد مظاهر العلاقة الجيلية التي تُكوِّنُ في بعدها الزمني، وأفقها الشعري، وأثرها الثقافي، التمردَ الإيجابي على الكائن سلفا.
رغم ذلك، يتعين علينا القول بأن مراودةَ النصِ الجديد عند أغلب الشعراء الشبان، لم تسلم من معوقات معرفية أدت إلى ضمور الجوانب التأملية والفلسفية في نصوصهم، كما لم تسلم من مشكلات فنية نتجت من قصور ثقافي حيال فهم الشعر الحديث، ومكاشفته نقدياً بما يتواءم ومخاطبته من داخله، أي ضمن سياقه الثقافي والمعرفي الذي نشأ فيه.